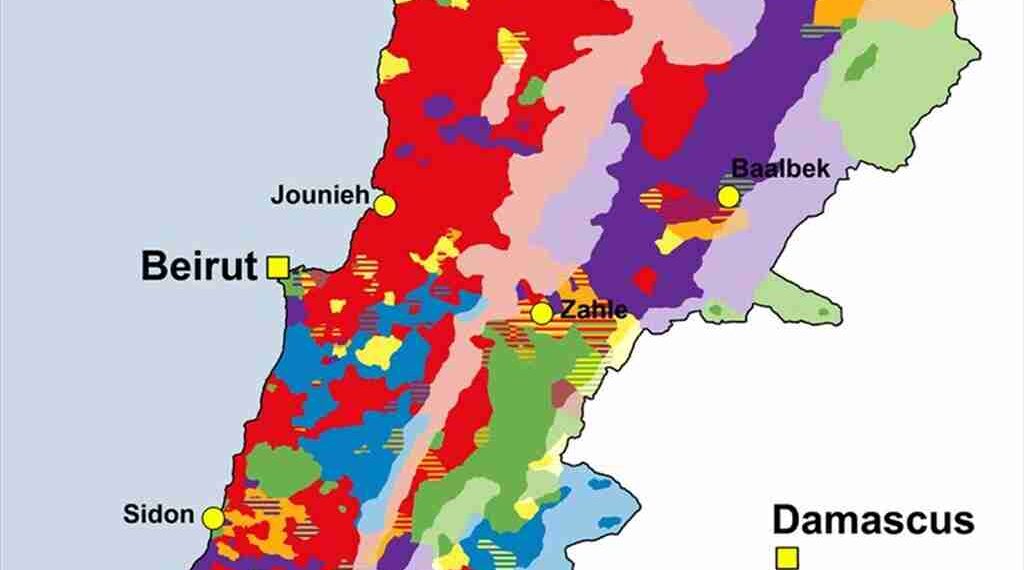من دون الدخول في جدال حول صحة قيام دولة لبنان الكبير، أو أنه كان خطأً تاريخيًا، فقد أصبحت الدولة اللبنانية حقيقة واقعة في العام 1920 لا مجال لنكرانها. لكن هذه الدولة كانت فريدة في خصائصها ومكوناتها، إذ ضمت طوائف بهوياتٍ وخصوصياتٍ وتجارب تاريخيةٍ متنافرة، وستحمل معها، منذ ذلك الحين، هواجس ديموغرافيةٍ، وتسابقًا على الأفضلية في الحكم والمغانم، من دون أن تتحول إلى وطن. إن «الميثاق الوطني» للعام 1943 كان خطوة جيدة وعامل دمج مجتمعي، لو جرى تطويره في العقود التالية لإزالة الالتباس في موضوع هوية لبنان ونظامه، وتفعيل الالتزام بتحييده، وتوزيع أكثر عدالة لثرواته على شعبه عبر الإنماء المتوازن. لذا، دخلت البلاد في حربين داخليتين وأزمات بين العامين 1958 و1990، فيما تسبب عدم تطبيق معظم بنود «اتفاق الطائف»، وأهمها نزع سلاح الميليشيات واللامركزية الموسعة، في قلق عند اللبنانيين على مصير بلدهم، على الأقل منذ تحرير الجنوب في العام 2000، في ظل منظومة سياسيةٍ حاكمةٍ بجذور ميليشياوية تعيد انتاج ذاتها وتتحاصص الفساد. كل هذا فتح أبواب لبنان على مشاريعٍ للطوائف، وصلت اليوم إلى الحديث عن الفدرالية علنًا، بالإضافة إلى دعوة البطريرك الراعي لحياد لبنان، فيما «تتفرج» الطوائف الأخرى على انهيار الوطن، وليس لديها مشروع للإنقاذ، حتى بالعقلية اللبنانية القديمة.
الفرضية التي سأثبتها، هي أن ما يطالب به موارنة اليوم، هو فدرالية لا تختلف، برأينا، في نتائجها المتوقعة، عن الانفصال عن لبنان الكبير (العودة إلى لبنان الصغير) الذي أراده إميل إده والمطران أغناطيوس مبارك وغيرهما، بسبب خوفهم على لبنان من هوية عربية- إسلامية تزحف عليهم، ومن ديمغرافية إسلامية متصاعدة ذات تأثيرات سياسية ومجتمعية وثقافية في المسيحيين. وإن فشل الفدرالية يفوق احتمالات نجاحها، وربما يؤدي إلى تقسيم لبنان، وعندها لن تكون هناك امكانية لإعادة جمع ما تفكك.
سأقارب الموضوع من خلال عرض موجز للعلاقات بين المسيحيين والمسلمين، ثم أتناول مسألتين أساسيتين: الأولى: الهواجس والاحباطات والخوف على المصير التي تجعل موارنة يجنحون اليوم إلى الفدرالية، مع الإشارة إلى أن لبنانيين كثر يتشاركون معهم في معظم تلك المخاوف التي سأعرضها، من دون تبني مشروع الفدرلة. والمقاربة الثانية، من خلال الإجابة على السؤال التالي: هل الفدرالية بالفعل مشروع لمستقبل لبنان موحدًا، أم ستؤدي إلى تقسيمه.
1- العلاقات المسيحية -الإسلامية: من تنافر هويتين إلى سلاحين وثقافتين:
من المعروف أن المسلمين، بغالبيتهم، رفضوا لبنان الكبير لاعتبارات تتعلق بهويتهم العربية-الإسلامية. فبين العامين 1909 و1920 كان عليهم الخروج من العثمنة بعد أربعة قرون من الحكم العثماني، إلى العروبة في مؤتمر باريس في العام 1913 التي كانت قاسمًا مشتركا لتلاقيهم مع المسيحيين، وأن يجبروا على القبول بالهوية اللبنانية في لبنان الكبير في العام 1920 ويخسروا بذلك فضاءهم العربي-الإسلامي. فكيف يستطيع انسان تغيير هويته ثلاث مرات خلال إحدى عشر سنة؟ أما المسيحيون، فكانوا متحضرين لكيانٍ مستقلٍ منذ عهد المتصرفية. لذا، خرجوا من «لبنان الصغير» إلى لبنان الكبير بهوية لبنانية مبتعدين، وخصوصًا في أوقات الأزمات، عن عروبةٍ ثقافية كانوا هم روادها، فيما طالبت أقلية مارونية منهم، في حينه، بالانفصال عن لبنان الكبير والعودة إلى «لبنان الصغير». وقد حذر إميل إده البطريرك الياس الحويك في العشرينيات من مخاطر نمو الديموغرافيا الإسلامية مستقبلًا على وضع المسيحيين في لبنان الكبير.
وقد تدرج اندماج المسلمين في الدولة الجديدة، من دون التخلي عن عروبتهم التي فضلوها على لبنانيتهم. ومن معالم ذلك دخول قيادات منهم في الإدارة في أثناء العشرينيات، وترشح الشيخ محمد الجسر لرئاسة الجمهورية في العام 1932، وإعلان قياداتٍ إسلامية في مؤتمر الساحل الثالث في العام 1936 عن إيمانها بلبنان الكبير، وأخيرًا انخراط المسلمين في تسوية الميثاق الوطني في العام 1943 الذي أسس لتعايش طوائفي على أساس «الديمقراطية التوافقية»، لكن بهويةٍ ملتبسة. فاعتبر الموارنة، بناء على ذلك، أن التوافق على لبنان أصبح غير قابل للتغيير أو التعديل، فيما تمسك المسلمون بعروبتهم، مجسدين ذلك بانجذابهم إلى الوحدة المصرية-السورية. فتسبب ذلك في تخويفٍ متبادلٍ بين الفريقين: المسيحيون من عروبة تزحف عليهم برداء الإسلام (الخلط بين العروبة والإسلام)، ومسلمون خائفون على عروبتهم بعد انضمام لبنان إلى الأحلاف، بتقربه إلى دوائر «حلف بغداد» ودخوله في «مبدأ ايزنهاور» في آذار 1957، من دون أن يكون مهددًا بالشيوعية.
ومنذ «اتفاق القاهرة» في العام 1969 وحتى اتفاق الطائف في العام 1989، فتحت أبواب لبنان على الخارج؛ فاستقوى المسلمون، مع تحول الديموغرافيا إلى مصلحتهم، ومعهم اليسار اللبناني، بالمقاومة الفلسطينية الموجودة على أرضهم لانتزاع مكاسبٍ من المارونية السياسية (رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش). فكان العامل الفلسطيني والخلاف على الهوية وراء النزاعات في الداخل واستغلالها من قبل الخارج، وبالتالي اندلاع حرب لبنان في العم 1975 ونعي الميثاق. فتطلع الموارنة إلى سورية أولًا، ثم إلى إسرائيل لنجدتهم، وتصاعدت دعواتهم إلى العودة إلى «لبنان الصغير» عبر الفدرلة أو التقسيم (كراسات القضية اللبنانية ومجلة العمل الشهري). هذا المشروع خبا بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 بتغيّر التوازنات من جديد، فعاد الموارنة إلى مشروع حكم لبنان كله.
وحتى قيام «ثورة الأرز» في العام 2005، انتشر الإحباط بين المسيحيين وبين كثير من اللبنانيين، من جراء عدم تنفيذ بعض البنود في «اتفاق الطائف»، كتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، ونزع سلاح الميليشيات، فضلًا عن خرق الدستور، وهيمنة النظام السوري على الدولة ومص اقتصادها مع أتباعه اللبنانيين. صحيح أن السوري انسحب من لبنان في العام 2005، بعد احتلال دام ثلاثة عقود، إلا أن نزول مسلمين ومسيحيين إلى الساحات، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خلف شعار رحيل سورية عن لبنان، لم يحول «الثورة» إلى مشروعٍ تضافر وطنيً تغييري عابر للطوائف، بالرغم من انضمام غالبيةٍ إسلامية إلى هوية لبنانية تحت شعار «لبنان أولًا». فانتقلت البلاد بعد التاريخ الأخير إلى مرحلة ساد فيها صراع سياسي بين تكتل 14 آذار وتكتل 8 آذار، في ظل وجود سلاحين وثقافتين (سلاح الجيش اللبناني وسلاح «حزب الله»، وثقافة لبنانية وثقافة فارسية يعمل الحزب على نشرها)، فضلًا عن مشروع الحزب للإمساك بلبنان ومؤسساته ومجتمعه لحساب «الولي الفقيه». ففقدت الدولة تدريجيًا سيادتها على أرضها وشعبها، وعلى حدودها وعلى قراراها السيادي، فيما انقسم المجتمع اللبناني على بعضه البعض، وأصبح لبنان رهينة سياسة إيران، وما يدور في المنطقة من صراعات بين أقطابها.
ومع الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي الذي بدأ يتخمّر منذ ما قبل «الانتفاضة اللبنانية (الاحتجاجات في العام 2011 بمناسبة الربيع العربي، و»طلعت ريحتكم» وبدنا نحاسب منذ العام 2015)، وفي ظل منظومة فاسدة حاكمة مضللة للشعب (سلامة الليرة بخير، فيما تنهار الاحتياطات وتتلاشى ودائع اللبنانيين)، أخذ الحديث يعلو من قبل موارنة عن طلاق بينهم وبين لبنان الكبير، عبر الدعوات إلى النظام الفدرالي، كرد فعل على الإحباط وانهيار الدولة اللبنانية وقيام دولة أقوى منها إلى جانبها.
2- أسباب جنوح مسيحيين إلى الفدرالية والانفصال عن لبنان الكبير
تأتي الخشية على الإنجازات والمستقبل وعلى المصير لدى المسيحيين في صدارة مخاوفهم، بأنه يتم القضاء نهائيًا على إسهاماتهم وأدوارهم في لبنان. ويشعر المسيحيون أنهم فقدوا الدولة التي أسسوها أو تأسست من أجلهم، ولم تعد تؤدي مهامها، سيادة وحدودًا ومؤسسات ودستورًا واقتصادًا وجيشًا وقضاء وأمنًا وخدمات، وما وصلت إليه الأوضاع فيها؛ من محاصصة الوزارات والمناصب ونهب المال العام وسرقة ودائع اللبنانيين وأحلامهم، وإذلالهم بتداعيات التضخم وانهيار النقد، وتدهور الأوضاع المعيشية للأسباب المعروفة، فضلًا عن انهيار الطبقة الوسطى وازدياد نسبة الفقراء. وانصبت شكوى المسيحيين أيضًا إلى نزع صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب «اتفاق الطائف»، من دون ذكر «المناصفة» التي حصلوا عليها وفق الاتفاق (رفيق الحريري: بدنا نوقّف العدّ)، بالرغم من تراجع ديمغرافيتهم، وتحول المناصفة المذكورة، عن عمد، إلى وهمية خلال مرحلة الاحتلال السوري.
خلال حرب لبنان، توحد الموارنة سياسيًا تحت مظلة «الجبهة اللبنانية»، وعسكريًا بقوة السلاح (توحيد البندقية) وبشكل دموي خطير على يد بشير الجميل. ومنذ عودة الجنرال عون من المنفى في العام 2005، تزعم بشخصه «مارونية سياسية جديدة» متحالفة مع «حزب الله» ومستقوية به (اتفاق مار مخايل 2006)، تعمل على اختزال المكونات السياسية المسيحية الاخرى المتمثلة بـ«المارونية السياسية» القديمة (القوات والكتائب والمردة)، فيما أصبحت كلمة بكركي غير مسموعة، مسيحيًا ووطنيًا. وقد استشعر قسم كبير من الموارنة، تدريجيًا، مساوئ «تفاهم مار مخايل»، وبعد ذلك «التسوية الرئاسية» في العام 2016 التي شارك فيها سعد الحريري، وجعجع بطريقة غير مباشرة عبر «اتفاق معراب» مع عون، وتأثيرها في انقلاب التوازنات الداخلية لمصلحة «حزب الله» وإمساكه بالمؤسسات، ما زاد من الصراع في داخل المعسكر الماروني، بدلًا من توحيده. وقد أصبحت الرئاستان الأولى والثالثة، منذ ذلك الحين، في جلباب «حزب الله»، فيما احتكر حليفه نبيه بري الرئاسة الثالثة من دون انقطاع.
وقد أدى الشرخ بين الموارنة إلى تآكل الطائفة المارونية من الداخل، تزامنًا مع تحول السنيّة السياسية إلى «سائبة» في عهد سعد الحريري، وتعرض جنبلاط إلى لـ«الحصار» في عرينه الجبلي من قبل «التيار الوطني الحرّ» و«حزب الله». فظهرت الشيعية-السياسية الأقوى على الساحة الداخلية، حتى مطالبتها الصريحة بمؤتمر تأسيسي (تصريحا نصر الله 2012، والمفتي قبلان 2020 برفض الطائف والميثاق)، أو بـ «المثالثة» التي تقلص من أدوار الطوائف الأخرى (مؤتمر سان كلو 2007)، وتترجم اليوم في وزارة المالية. إشارة إلى أن رفيق الحريري احتكر لتياره وزارة المالية للطائفة السنيّة في معظم الأحيان. إن الحجة بأن الطوائف الكبيرة لها الحق وحدها باحتكار الوزارات السيادية، هو كلام سخيف، ويدل على عقلية قرن أوسطية متخلفةٍ لا علاقة لها بالدولة الحديثة القائمة على الكفاءات.
ومن ضمن مخاوف المسيحيين واللبنانيين وإحباطهم سلاح «حزب الله» بعد تحرير الجنوب في العام 2000 الذي شرعته الحكومات اللبنانية في بياناتها الوزارية، وفق مقولة «جيش شعب مقاومة»، فجعلت الحزب يتفوق بذلك على الجيش الشرعي وعلى المجتمع، وتفقد الدولة بالتالي سيادتها على أرضيها وحدودها، فيما لم يترجم الحزب وعوده بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية بعد التحرير. فكيف تقوم دولة لبنانية قوية في ظل سلاح دويلة أقوى منها؟ ولم يعد بإمكان الدولة اللبنانية أن تفرض سيادتها على حدودها وأراضيها من ناحية الشرق، وبالأخص في جنوب البلاد، امتثالًا للقرار الأممي 1701، في ظل التراخي العربي والدولي والتوافقات الخارجية على حساب لبنان التي استفاد الحزب منها للعودة بسلاحه إلى المنطقة بعد العام 2006، والتحكم بقراري السلم والحرب مع إسرائيل.
صحيح أن اجتياح «حزب الله» وحلفاؤه بيروت في أيار من العام 2008 لم يشمل مناطق المسيحيين، إلا أنه شكل رسالة تهديد إلى الجميع بأن سلاحه يوظف في الداخل اللبناني، وليس للدفاع عن حدود لبنان من اعتداءات إسرائيل التي تجتاح الأجواء والمياه اللبنانية كما تشاء. إشارة إلى أن رئيس الجمهورية عون كان يغطي هذا السلاح عبر تصريحات (على الأقل حديثه الواضح مع السفير الأميركي فيلتمان في 13 آذار 2007 بأن السلاح لا يشكل تهديدًا للداخل اللبناني)، وكذلك فعل معظم الطبقة السياسية، حتى سعد الحريري نفسه في بعض المناسبات.
تزامنًا، أدى الإرهاب المسلح الذي ضرب لبنان منذ نهاية القرن الماضي، وتأثر شماله وجنوبه بالأصولية الإسلامية، وتوسيع تركيا نفوذها هناك، وحديث تنظيم «فتح الإسلام» الإرهابي عن إقامة إمارة إسلامية في شمال البلاد، والاشتباك العسكري الخطير بين الجيش اللبناني والتنظيم الأخير، صيف العام 2007، إلى رفع منسوب المخاوف المسيحية من مشروع لأسلمة لبنان.